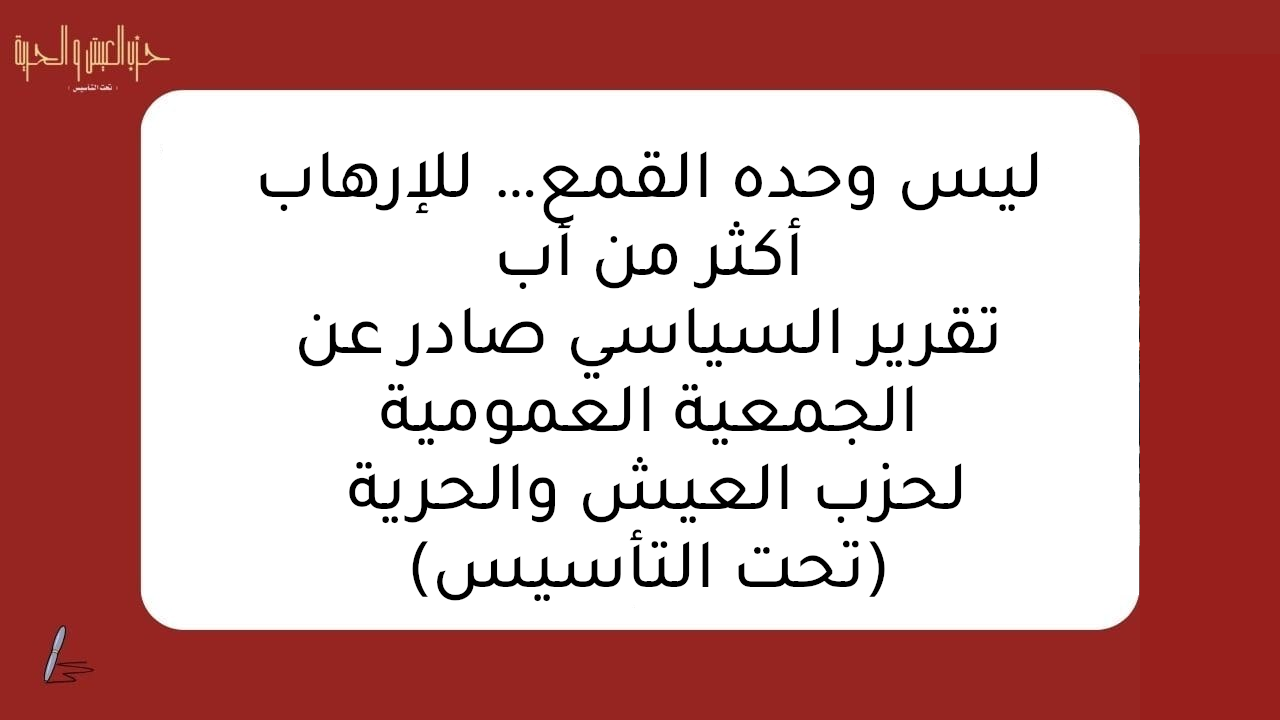الجمعية العمومية لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
دعوة للحوار بشأن قضية الإرهاب
“إما الاشتراكية أو البربرية ” يجب أن يبقى هذا الشعار هو موقفنا المبدئي، فالتناقضات الاجتماعية و الاستغلال والقهر الذى تعيشه البشرية يجعل التخلص من البربرية بكل صورها غير ممكن، فالتوحش هو منتج واقع القهر والذعر والاغتراب الذى تعانيه الإنسانية فى ظل نظام عالمى ظالم ومتبلد، عالم تزداد تناقضاته فيزداد توحشه وتنمو فى ظله كل نزعات العنف والعنصرية والطائفية والذكورية فى المجتمعات الإنسانية، فدول الشمال تطلق النار على المهاجرين الشرعيين فى ظل بطالة متزايدة تعتصر جنوب أوروبا، بينما يهاجر الملايين من الشباب الأوروبي من جنوب وشرق أوروبا للشمال بحثا عن العمل . يهاجر الآلاف من هؤلاء إلى الجنوب للانضمام إلى مليشيات داعش المتطرفة التى أصبحت تسيطر على مساحات شاسعة من المشرق العربي الذى تفككت دوله التاريخية تحت تأثير غزو خارجي فى العراق أو فى سياق ثورة شعبية على الأوضاع البائسة كما حدث فى سوريا، وعلى اختلاف الأسباب فنحن نشهد نهاية هذه الدول التي حكمتها نخب عسكرية أدارت عملية انحطاط طويلة أدت إلى انفجار هياكلها السياسية المتصدعة فكان تفككها لصالح صراع ميلشياوى طائفى مرير أمرا طبيعيا – إن جاز التعبير- فى ظل صراعات إقليمية يغذيها الاستقطاب الطائفي والمصالح الضيقة للنخب الحاكمة وفي ظل تناقضات متفاقمة للنظام العالمى يدفع به للقبول بل للاستثمار في الفوضى للحفاظ علي مستويات الاستغلال والنهب ؛ الأمر الذى يجعل هذا الصراع الميليشياوى هو أحد تجليات الأزمة العالمية وامتداداتها الإقليمية ، أي – عمليا – كل هذا التوحش الذى يحيط بنا من ذبح وقتل ورجم وفوضى هو تجليات لأزمة النظام العالمي ولهذا فإن شعار “الاشتراكية أو البربرية” شعار مناسب جدا للمشهد. يجب علينا الآن أن نعي أن هذا الشعار يقف علي النقيض تماما من هذا التفسير السائد فى مصر وسط المجموعات الثورية بعد الثالث من يوليو من “أن الانقلاب هو الإرهاب أو أن القمع يولد الإرهاب”. لا يعني هذا أن القمع ليس أحد مسببات الإرهاب، لكن المشكلة أن مقولات كهذه تبرر- سياسيا- البربرية ، وتروج- عمليا –(*) لقبول حقيقة بالغة الخطورة هى أن حل مواجهة الإرهاب وبربريته هو أن يتم إدماجه في السلطة! فالأطروحة التى تتبناها أجنحة داخل الإدارة الأمريكية بضرورة إدماج التيار الإسلامي في السلطة في بلادنا قائمة بالضبط على هذا التصور وهو أن تجليات أزمة النظام العالمي من تطرف ديني وإرهاب يجب إدماجها في النظام العالمي لكي نأمن شرورها.
إن تبرير الإرهاب الإسلامي واعتباره مجرد نتيجة للقمع هو تجاهل لمشروع الحركة الاسلامية كما تعلن تنظيماته ورموزه بل وجمهوره عنه وليس كما نقرأها نحن، كما أنه أيضا اختزال للدور الذى لعبته الدولة في رعاية “الإرهاب” والذي يتجاوز بكثير موجة القمع الأخيرة بل والقمع وحده أصلا.
الدولة المصرية والصحوة الإسلامية
إننا لا نواجه الآن مجرد موجة جديدة من موجات العنف الإسلامي بل إننا أمام حصاد ما يعرف بالصحوة الإسلامية كاملة، فمنذ أن قرر السادات استدعاء الحركة الإسلامية لضرب الحركة التقدمية المتصاعدة على خلفية النكسة، قبل أن ينقلب عليها وتنقلب عليه. لم يعد يمكن قراءة تاريخ هذه العقود الأخيرة بدون قراءة مشروع الحركة الإسلامية، فمبارك قد أتي للحكم فى مشهد الانقلاب الإسلامي على السادات وأسس نظامه فى سياق تحولات إقليمية أرّخت لبداية تحلل أنظمة التحرر الوطنى (تحلل دولة يوليو أو العصر البعثى فى المشرق العربي) وهيئت البيئة المواتية لصعود إسلامي كبير. وبلا شك كان تصاعد الإرهاب الموجه للدولة فى الثمانينات أحد العوامل المؤسسة لنظام مبارك فى صبغته الأولى، والذى سعى لتأسيس دولة بوليسية تحاصر كل أشكال العمل المستقل وتصفّي أى حيوية وكل حركة، كما تتصدى للإرهاب الموجه ضدها بالأساس وضد المجتمع بدرجة أقل. تحت هذه الصيغة والضغط الأمني المستمر، تراجع الإرهاب الموجه للدولة لكن في مقابله تغلغل إرهاب شامل للمجتمع باسم «الإسلام» يبدأ من المآذن عالية الصوت وفرض(*) الحجاب فى مدارس الدولة على الطالبات، ويمتد ليشمل أسلمة لمناهج التعليم فى كل مراحله وإعطاء دور أكبر للأزهر في الحكم مع انغلاق فكري ورجعية متزايدة فيه، وصولا إلى العنف الطائفي من قبل الإسلاميين وبتواطؤ – وأحيانا – مشاركة الدولة. أى-عمليا- تم تقسيم الأدوار بين السلطة والحركة الإسلامية بحيث تسود السلطة مجموعات مصالح منعدمة الرؤية السياسية تتشارك أو تتقاتل حول الغنائم بينما تحافظ على الاهتراء التنظيمي للمجتمع وترسخه، فتتركه –عمليا – تركة للصحوة الإسلامية وتخلي أمام الحركة الإسلامية النامية باطّراد مساحات كبيرة في المجتمع الضعيف، وتوجه له الضربات من حين لآخر إذا تجاوزت الخطوط الحمراء. فكان تراجع الإرهاب هو-عمليا – نتاج قناعة عند قطاعات واسعة من الحركة الإسلامية أن هذا النمو سيمكنهم – في ظل الترهل والتفكك اللذين تعاني منهما الدولة وانحصار الحركة التقدمية – من الوصول أو على الأقل مشاركة السلطة فى فرصة ما.
مسار الإرهاب ومسار الثورة
لم تكن ثورة يناير بنت الصحوة الإسلامية بل على العكس هى بنت حركة مدينية “مدنية”(*) – إن جاز التعبير – نمت مع بداية الألفية بالأساس فى مواجهة صيغة مبارك البائسة برمتها. لقد راهنت أطراف علمانية مهمة خططت لثورة يناير وشاركت فيها أن الثورة ذاتها فرصة لإرباك الحركة الإسلامية وتجذير التناقضات داخلها وتفتيت مشروعها المتسلط الإرهابي، لكن هذا الرهان اصطدم بحقيقة أن قلب الحركة الإسلامية “السلفي”(*) يري في يناير فرصته المنتظرة، وكان الرهان بالأساس على الإخوان باعتبار أنهم الفصيل الإسلامي الأكبر والذى شارك بحذر فى محطات النضال الديمقراطي السابقة على الثورة. إلا أن الأخوان ومنذ استفتاء مارس 2011 عملوا على تغذية حلم الصحوة تحت شعار “آن الأوان” وبدءوا(*) التعبئة الإسلامية التي استمرت في كل محطات الصراع مرورا برابعة وحتى الآن.
كان استفتاء مارس حاسما، فمعركة الدستور كانت معركة ملهمة جدا لجمهور الحركة الإسلامية الذى أصبحت قطاعات منه علي يقين أن الفرصة قد سنحت، فتبنِّي خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري تحت شعار “الانتخابات أولا” سيمكنهم من السيطرة على البرلمان ومن كتابة دستورهم الإسلامي وتأسيس دولة إسلامية باسم الثورة، ولهذا فإن التعبئة الإسلامية السلفية (*) التى أدارها الإخوان جعلت من حلم الصحوة فى تأسيس دولة الإسلام مطلب للجمهور الإسلامي غير قابل للتفاوض، الفشل فيه يعني عمليا اللجوء للإرهاب، وهذه هي رسائل منصات النهضة ورابعة حتى قبل الفض والعنف، فالتعبئة الإسلامية المبكرة حصرت الخيار إما في التمكين أو الإرهاب، والعودة للتحقيقات مع الشباب المتهمين بالأعمال الإرهابية الأخيرة تؤكد أن ارتباط الكثير من هؤلاء الشباب بالسياسه بدأ مع “أريد أختي كاميليا” وجمعة قندهار وانتهي بالخيارات الجهادية، أي بدأ بعد أن قدم الإخوان مشروع يناير 2011 للجمهور الإسلامي على أنها فرصة الصحوة التاريخية.
لم تكن تعبئة مارس الإسلاميه علي عكس رغبة الدولة حينها فلقد دفع التحالف الأمريكي الإخوانى المجلس العسكري لرسم خارطة الطريق على هذا النحو، بل إن المجلس العسكري وهو يقتل ويقبض على الآلاف من شباب الثورة كان قد أفرج عن مجموعه كبيرة من الجهاديين تحت ضغط الإخوان الذين وعدوا الغرب أن الإفراج عن هؤلاء هوعربون محبة وخطوة مهمة فى مسار الاستيعاب بالحب وحصار الإرهاب، أى أن مشاركة تنظيمات ورموز الحركة الإسلامية كلها – حتي الجهادية منها – فى الحكم هو السبيل الوحيد لمقاومة الإرهاب (الشراكة مع الإرهاب هى الحل). ومع ذعر المجلس العكسري حينها بعد تورطه في عدة مذابح – وعدم تقبل فكرة الحكم العسكري المباشر لدى الحركة السياسية والمجتمع الدولي – كان خيار الاستسلام للإخوان خياره الآمن حينئذ.
كانت الحركة الديمقراطية فى المرحلة الانتقالية مترددة فيما يخص الحركة الإسلامية، وكانت أكثر ميلا لتجاهل هذا التظاهر الإسلامي القوى. فكان شعار “تجاوز الاستقطاب المدني الديني” هو عمليا شعار للضغط على القوى الديمقراطية للتسامح مع الطغيان الإسلامي في شهور ما بعد الثورة في سعي لاجتذاب عناصر من الحركة الإسلامية للحركة الديمقراطية. واعتبرت بعض الأجنحة الثورية الاستثمار فى معركة الدستور هو استثمار فى معركة ثانوية، كما لم تواجه بحزم القوى الديمقراطية – التى ابتزتها جرائم النظام السورى – ذهاب الكثير من كوادر الحركة الإسلامية للتنظيم والتدريب والقتال في سوريا بين ٢٠١١ و٢٠١٣، والذين تحولوا إلى رصيد استراتيجي للتنظيمات الجهادية فيما بعد، هذه الرحلات الذى كان ضالعا فيها طيف واسع من المحسوبين علي الحركة الإسلامية من حازم صلاح أبو اسماعيل لشباب التيار المصري ومصر القوية. فمحاربة النظام “العلوي-الشيعي” وتشابكها مع المزاج المناهض لاستبداد النظام السوري الميليشياوي المافياوي والمزاج المناهض لحكم الأنظمة العسكرية جعلت المعركة جاذبة جدا لقطاع واسع من جمهور الحركة الاسلامية بكل أطيافه بل جاذبة لشباب ألهمته الثورة.
البيئة الحاضنة:
بالطبع مجزرة رابعة خلقت جمهور واسع من المتعاطفين والمبررين للإرهاب، وبالطبع هناك عدد من الشباب سينضم للتنظيمات الإرهابية كرد فعل لكل أشكال القهر الاجتماعى السياسى، فالحركات الأيديولوجية العنيفة هى أحد منتجات الصراع الاجتماعى والأيديولوجى في المجتمعات الإنسانية، وكلما اتسع المجال السياسي ومساحات التعبير عن الرأى و تجذرت الممارسة الديمقراطية وانتظم المواطنون فى تنظيمات طواعية كلما تم حصار الظاهرة الإرهابية وحرمانها من تعاطف واسع أو حاضنة شعبية كبيرة. لكن هذا البعد يتجاوز ما حدث في الثالث من يوليو ٢٠١٣ الذي يُروَج له زيفا بأنه اللحظة المؤسسة للإرهاب.
إن حصار دولة يوليو للمجتمع والحفاظ على الاهتراء التنظيمي له قد جعل تشكيلات اجتماعية واسعة من عصبيات وعائلات تنشط اجتماعيا واقتصاديا بعيدا عن حضور الدولة المادى والقانوني، ففشل مشروع التحديث جعل حضور الدولة مرتبطا أساسا بالقمع أو بالصفقات غير المشروعة وليس بإدماج لقطاعات اجتماعية واسعة علي أرضية المواطنة في سياق إدارة التوازن الاجتماعي. لقد اعتمد نظام مبارك ثنائية القمع/الصفقة ومارسها مع قبائل وعائلات الصعيد وبدو سيناء والصحراء الغربية، وتصالح مع نشاط مافيوي واسع في كل مكان في مصر كان الأمن شريكا فيه. مع الثورة استفادت هذه التشكيلات وهذا النشاط من انهيار منظومة الأمن في التوسع في النشاط والنفوذ وسعى الإخوان والسلفيون لمد الجسور مع هذه التشكيلات باعتبارها رصيدا لهم في الصراع حتى لو تركت لهم نشاط التهريب أو التصالح مع مافيات الباعة الجائلين وتجار المخدرات والسلاح، ولهذا فبعد الثالث من يوليو خلق هذا التحالف الطبيعي بين الحركة الاسلامية والتشكيلات الاجتماعية والمافيات الرافضة لعودة الدولة/الأمن للمشهد. فالعمل المافيوي يستفيد من مساحات الفراغ كما تستفيد منه القوي الجهادية، مما خلق بينهم تحالف في أماكن عدة وأصبح اقتران عمليات التهريب بالعمليات الإرهابية عاملا مشتركا في كثير من الحوادث، وأصبح اختطاف العصابات الإجرامية للأقباط وطلبُ فدية أكثر سهولة بعد استباحتهم من قبل أنصار الشرعية الإسلامية وخاصة بعد فض رابعة ؛ أى أن التنظيمات الجهادية تتغذى على الوضع التنظيمي المهترئ للمجتمع وعلى العلاقة الأبوية المشوهة التى صاغتها دولة يوليو مع المجتمع. بكلمات أخرى، يتغذى الإرهاب بالأساس علي حالة الاغتراب العميقة بين الدولة والمجتمع الذي يقبع غالبيته في الهامش بالمعني السياسي والاجتماعي ودون أي يعي نفسه سياسيا أو طبقيا بشكل مستقل.
وتظل أحد أهم النماذج الدامغة على دور الدولة في تغذية الإرهاب هو جامعة الأزهر، فجامعة الأزهر هي أحد نماذج شراكة الدولة مع الصحوة الإسلامية فالتعليم الأزهري كان ومع بداية الثمانينات قد بدء في التوسع ليشمل كل مراحل التعليم الأساسي والجامعي، وكان هذا التوسع هو استجابة دولاتية للصحوة الإسلامية ومحاولة منها لمشاركة الحركة الإسلامية الأيديولوجية الدينية في سعي فاشل لتأميمها، فانتشرت المعاهد الأزهرية في كل ربوع مصر واتسعت جامعة الأزهر لتجعل من التعليم الأزهري مسارا بديلا للتعليم، تمتزج فيه العلوم الشرعية بالعلوم الدنيوية في صيغة أتاحت مساحة واسعة للحركة الإسلامية السلفية ممولة من ضرائب المصريين مسلمين وغير مسلمين. كانت الاستجابة الواسعة من الجمهور الريفي وحتى المديني للتعليم الأزهري قد جعل منه أحد أهم أوعية تفريخ الكوادر للحركة الإسلامية بل جعل منه جسدا رجعيا بالغ التأثير خاصة مع انحطاط مستوي التعليم الأزهري مقارنة بالتعليم الجامعي العادي (المنهار بدوره) وفقر وبؤس غالبية طلابه، والذي يظهر جليا في مدينته الجامعية التي تمثل واحدة من أكبر المدن الجامعية في مصر والتي يعاني طلابها تحت تأثر انحطاط التعليم والفقر أوضاعا كاشفة عن واقع الاغتراب الذي تنتجه الدولة ويتغذى عليه الإسلاميون، ولهذا لم يكن غريبا أن تكون أكبر الصدامات الدموية بين الدولة والطلبة هي في جامعة الأزهر ليس بعد رابعة، وإنما قبل هذا بكثير في مظاهرات طلاب الأزهر ضد فاروق حسني بسبب انتقاده الحجاب 2006 ومظاهراتهم ضد طبع رواية ” وليمة أعشاب البحر ” ٢٠٠٩ وقضية عرض الفنون القتالية المعروفة إعلاميا بـ”مليشيات جامعة الأزهر” ٢٠٠٦. فالتعليم الأزهري وهذه الصدامات الدموية أمثلة دالة علي تواطؤ الدولة مع الحركة الإسلامية التي ينتهي في النهاية لصدام دموي لا يمكن تجنبه.
الطائفية وغيرها من الانحيازات الرجعية
أخيراً لا يمكن مناقشة موضوع الإرهاب بدون مناقشة الاستقطاب الطائفي الذي تغذت عليه “الصحوة الإسلامية”، فالصحوة الاسلامية السنية تغذت علي الاستقطاب الطائفي الشيعي السني في المشرق العربي، والذي تورطت فيه دول المشرق، فحكم صدام حسين قد تورط في حرب طويلة مع إيران مدعوماً من السعودية والأمريكان وارتكن علي عشيرته السنية في قمع الانتفاضات الشيعية المتوالية بعد حرب الخليج، وفي مقابل هذا ارتكن النظام السوري علي الأقلية العلوية وتحول الجيش السوري إلي ميليشيات علوية مدعومة من القوي الإقليمية الشيعية في مواجهة المليشيات السنية التي ورثت الثورة السورية بعد أن صفت طبيعتها الشعبية، وربما من المفارقات أن فلول البعث العراقي هي من أهم الفصائل الداعمة لداعش التي تحارب الجيش السوري البعثي المدعوم من إيران والقوي الشيعية! أي – عمليا – الصراع الطائفي هو عنوان الصراع الإقليمي الدائر في المشرق العربي والتي تتغذي عليه القوي الجهادية السنية المدعومة من الخليج السني تاريخيا.
وفي مصر، تغذت الحركة الإسلامية في صحوتها علي التعصب الطائفي ضد الأقباط وغذت الاستقطاب الطائفي في كل مصر وساهمت في تأجيج الفتن الطائفية بتواطؤ بل بمشاركة الأمن الذي تبني الألعاب الطائفية باعتبارها ألعاب تعمّق بؤس المجتمع وتبرهن علي ضعفه فتضفي شرعية علي الحضور الأمني الكثيف في المفاوضات الاجتماعية كما تمنح غطاء لإجراءات قمع الإسلاميين وكذلك قمع المجتمع وحصار نضالاته، هذا بالإضافة الي غرق الدولة المصرية الأيديولوجي في مسألة الهوية والذي جعلها مريضة بدورها بالأمراض الطائفية وبالتشكك في الأقليات، فدولة يوليو تأسست علي أرضية هوياتية قومية/إسلامية رغم بعض الملامح التقدمية التي حضرت بقوه في الأعوام الأولي لحكم عبد الناصر والتي تراجعت سريعا منذ نكسة يوليو وعبر كل محطات الانحطاط. وبقراءة الاجراءات والخطاب الذي تتبناه الدولة بعد يوليو 2014، نجد أن هذه السمة مستمرة ؛ فالدولة التي أعلنت حربا على الإسلام السياسي مستمرة بشكل مطرد في تأبيد التقسيم الطائفي للمجتمع بتبني المادة الثالثة من الدستور الموروثة من حقبة الإخوان ودستورهم لعام 2012 ورعايةِ كتابة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين باعتباره شأنا مسيحيا مغلقا تتولى مسئوليته الكنائس وإعادةِ السيدات الهاربات من أسرهن قسرا، ومستمرة في التمييز الديني بضرب الأقباط المتجرئين على التذمر من اختفاء بعض النساء، ورفض إصدار قانون دور العبادة الموحد لاعتبارات الأمن القومي أو رفض تسمية مدرسة على اسم شهيد مسيحي من ضحايا الإرهاب ورفض إخراج التمييز الديني من نطاق صلاحيات مفوضية مكافحة التمييز في مشروع القانون الجديد والتساهلُ مع جرائم خطف الأقباط للفدية في الصعيد والتراخي في جبر الضرر والإنصاف لضحايا العنف الطائفي بعد 30 يونيو و14 أغسطس (فض رابعة). وهي كذلك تتبنى بازدياد خطابا وإجراءاتٍ محافظةً ورجعية متمثلة في تزايد حملات مكافحة الفجور وازدراء الأديان والفعل الفاضح في الطريق العام وتبني أشكالا من “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في شكل الشرطة المجتمعية، وتبني خطابا حاميا محافظا في مواجهة التحرش الجنسي وليس خطاب حرية النساء في المشاركة في المجال العام وتأمينه من أجل هذا ورفض مشاركة النساء في القضاء رغم الإقرار الدستوري. أي أن الدولة تحارب الإرهاب الإسلامي لكنها تحافظ بل وتحاول تأميم مكونات التوجه الأيديولوجي للحركة الإسلامية.
أنظمة التحرر الوطني المستبدة لم تستتب شرعيتها إلا بتبني بائس لقضية الهوية كخلفية أيديولوجية للحكم في مواجهه إسرائيل والغرب، ووجدت نفسها مع التحلل تتصارع مع الصحوة الإسلامية علي أرضية الهوية ؛ الأمر الذي جعل منها في نهاية الأمر طرفا في الصراع الطائفي المؤسس للمشهد الحالى.
ما العمل؟
إذا كنا نؤمن أنه “إما الاشتراكية أو البربرية” فيجب علينا أن نناضل من أجل تحرير المجتمع من الاستغلال والعبودية والقهر والاغتراب، وهذا الصراع هو صراع مع السلطة وفي المجتمع أيضاً، فلا تحرر للمجتمع بدون تبلور قوى ديمقراطية متقدمة مناضلة تنمو لتنتزع مساحات في سياق صراع مع الدولة ومع القوي الرجعية في المجتمع، وبالطبع النضال من أجل مجتمع حر لا طبقي هو هدفنا إلا أن النضال هذا لا يستقيم بدون موقف حاسم من مسألة الهوية التي تتنافس فيها الدولة مع مكون اجتماعي أكثر رجعية منها يتغذى بالأساس علي مسألة الهوية وعلي الاستقطاب الطائفي وكل ميراث التخلف وكل البؤس ممتزجا بنفس التصورات الرأسمالية عن إدارة الثروة في المجتمع بلمسات تراثية لا تغير من جوهره. وكلما انحصر وجوده هذا التيار في هياكل السلطة كلما ازداد توحشا وعنفا واستدعاءً للهوية، فاعتبار أن قضايا المواطنة قضايا هامشية أو مؤجلة هي تواطؤ في الحقيقة مع الرجعية من قِبل قوى مثلنا لا معني لوجودها إذا لم تدافع عن التقدم بدون مواربة.
يجب التحرر من شعار “القمع يولد الإرهاب” لصالح شعار”لا للقهر وكل أشكال الاستغلال” فموقفنا من القمع هو تحيز للحرية والتقدم وليس تبريرا لممارسات القوي الرجعية وظهيرها الشعبي. هذه القوى الرجعية التي يجب أن تُدحر تنظيماتها الإرهابية المتوحشة دحرا وأن نعمل علي حرمانها من حاضنتها الشعبية بنضال ديمقراطي جذري يقدم للمجتمع بدائل التقدم والحرية كأدوات للخلاص من القهر ومن الإرهاب أيضاً، نضال يبلور أمام الطبقات الشعبية سبلا ترى فيها مصالحها وأهمية الدفاع عنها بالانتصار على التحيزات والتصورات الأيديولوجية التي تعيق رؤيتهم لهذه المصالح. لذا فنضالنا هو نضال ضد كل مكونات الرجعية: الطبقية والأبوية والذكورية والطائفية.
ومن أجل تفعيل هذا الشعار- عمليا – علينا أن نعترف أنه لا مفر من استخدام عنف الدولة ضد عنف الجماعات الإرهابية لكن بشكل قانوني منضبط وكفء يقضي على قلب التنظيمات المسلحة دون أن يوسع حاضنتها الشعبية، وأن نسعى لانتزاع أكبر قدر من الإصلاحات الديمقراطية ولمكافحة الاجراءات الاستبدادية التي تُتخذ بحجة حالة الطوارئ ورفضِ أى انتهاكات لحقوق المواطنين الأساسية فى مناطق الصراع ورفضِ كل الدعاية الأمنية المشكّكة فى ولاء أى فئات شعبية ورفض لأى اتهامات جزافية للأهالي فى مناطق المعارك ، وأن نضغط من أجل مواجهة التهميش والفقر بإجراءات عاجلة تستجيب لمطالب ونضالات الطبقات الكادحة، وأن نعمل على مكافحة التمييز والتخلف بمكافحة الإجراءات المرسخة له في مؤسسات الدولة التعليمية وغيرها، وتغيير التشريعات والسياسات القائمة والعمل مع الجماهير على نشر المفاهيم والثقافة التقدمية الإنسانية والبدائل الشعبية التضامنية.