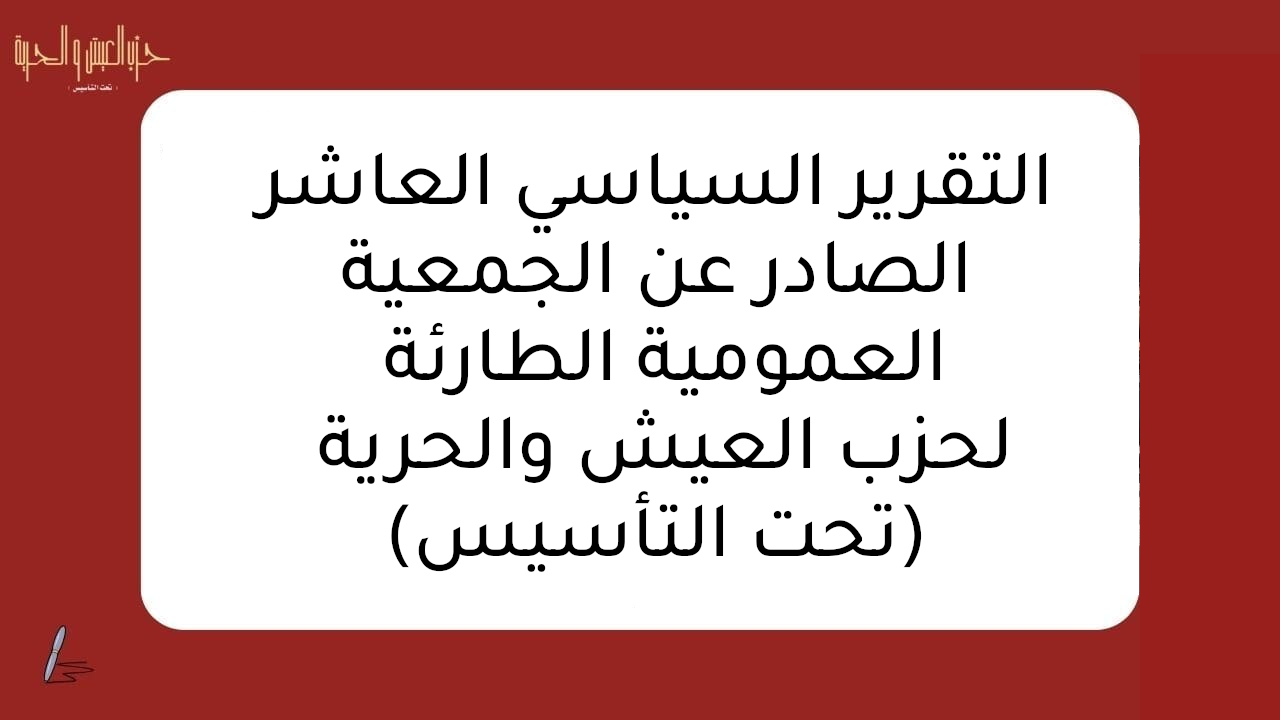مقدمة:
بينما تُسدل الستائر على مشهد تسلم السيسي لمهام منصبه في ولاية جديدة، تبشر الأبواق الدعائية للنظام الحاكم المصريين بأن الأربع سنوات المقبلة ستكون مرحلة “جني ثمار” السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي طبعت الفترة الأولى للسيسي بطابعها، وأن سنوات المعاناة في طريقها إلى الزوال لصالح أعوام من الرخاء النسبي. صدقت تلك الأبواق… في الواقع ستكون المرحلة المقبلة هي موسم جني الثمار، ولكن أي ثمار؟ إنها ثمار سنوات عجاف من السلطوية الفجة والنهب المنظم لمدخرات المصريين ومعاشهم وإعادة تخصيصها لمصلحة شبكة من المصالح المرتبطة عضويًا، والتي تمتد من الشرائح العليا للبيروقراطية العسكرية والأمنية والمدنية مرورًا بفئات رأسمالية مالية مرتبطة بشكل وثيق بشبكة أخرى من الرأسمالية الاحتكارية ورعاتها في الإقليم والعالم. تجني تلك الفئات ثمارها عبر تحصين مواقعها بالمزيد من حكم الإرهاب وتجفيف الحياة العامة والانخراط النشط في تحالفات إقليمية وعالمية يمينية شرسة لا تتورع عن تخريب مقومات الحياة في بلدنا والإقليم، وكل ذلك يتم تحت شعارات وطنية زاعقة مفرغة من المعنى والمضمون. وفي المقابل، لا تجني الغالبية الكاسحة من جماهير الشعب المصري، وفئاته الأكثر انكشافًا وضعفًا من النساء والأقليات الدينية، إلا الُحصرم والمرار، ثمنًا لإجهاض انتفاضاتها المجيدة بسبب جملة من العوامل الذاتية والموضوعية.
وبينما يفتتح السيسي ولايته الثانية بهذا المشهد الكئيب، لا تخلو الصورة من توترات داخل هذا الحلف الحاكم الجديد مرشحة للتعمق في السنوات الأربع القادمة، كما لا تخلو الصورة من فرص للنضال الديمقراطي والاجتماعي- فرص يبدو اغتنامها أصعب من ذي قبل وإن كان ليس مستحيلًا بشرط إدراك المعارضة الديمقراطية، وفي القلب منها الأنوية اليسارية البازغة، لطبيعة النظام الجديد وخريطة الحلف الحاكم وشروط اللعبة الجديدة الصعبة، وكذلك تخليها عن أوهامها المريحة التي ارتكنت لها طويلًا وقادتها للرهان على تناقضات في النخبة الحاكمة لم تنضج بعد، أو رهانات لا تقل عبثية على السلطوية الإسلامية في مقاعد المعارضة والتي تتخبط في تيهها التاريخي منذ يوليو ٢٠١٣.
وحتى ندرك طبيعة تلك التناقضات المستقبلية وما يرتبط بها من فرص وسيناريوهات محتملة للأربع سنوات المقبلة يقتضي الأمر إعادة التذكير بما حاولنا رصده من ملامح لنظام السيسي المتفرد، ورصد دقيق لخريطة المستفيدين والداعمين لمشروعه، وكذلك جمهور الخاسرين المتعاظم يوميًا، ثم تحديد كل من مواطن التناقض المحتمل بين أجنحة الحلف الحاكم ومواطن عجز المعارضة الديمقراطية تمهيدًا للوقوف على الفرص الضئيلة التي يتيحها هذا المشهد المعقد.
نظام السيسي بين يوليو ويوليو:
لا يمكن فهم ما بدأ في يوليو ٢٠١٣ والذي نتجهز لحصد ثماره في السنوات المقبلة، إلا بالإحالة لما حدث في يوليو ١٩٥٢، إذ أن الكثير من ملامح النظام الحالي التي اكتملت أو تكاد، يمكن تبينها في مرآة النظام السابق على انتفاضة يناير ٢٠١١.
يعتبر الكثير من المحللين الليبراليين والإسلاميين، وحتى بعض اليساريين، أن نظام السيسي هو محض امتداد حرفي، أو محاولة لإعادة تأسيس خشنة، لنظام يوليو ١٩٥٢ سواء في طوره التنموي أو في طوره الرأسمالي التابع. ملامح التشابه، وفقًا لهذه الآراء، تتمثل في السعي لفرض الوصاية على الحياة العامة عبر تنظيمات إدماجية نقابية وأهلية لا تعترف بالتعدد أو الاستقلال، وإغلاق المجال السياسي إلى حين إنجاز مهمة وطنية ما وتركيز السلطات في موقع واحد، هو مؤسسة الرئاسة، مع فرض شروط غير مواتية لعمل الرساميل الخاصة، سواء في شكل تدخل واسع للدولة (مستبدلة الآن بالمؤسسة العسكرية) أو في شكل محاباة نخبة رأسمالية مختارة بعناية من “المحاسيب”. وفي كل الحالات يستند إغلاق المجال العام المؤقت إلى رشوة اجتماعية تعول بها موازنة الدولة قطاعات واسعة من المواطنين عبر أنظمة ضمان اجتماعي مختلفة أو عبر التوظيف المباشر في الخدمة المدنية أو دعم عيني ومادي مباشر. و يستند هذا العقد الاجتماعي على خطاب وطني زاعق قد يصل حد التطرف يلهم السياسات الثقافية والتعليمية ويضع حدودًا على النقاش العام في الكثير من القضايا، خصوصًا ما يتعلق بمسألة الأقليات الدينية والنساء والعلاقات الخارجية.
لا يعنينا هنا حسم الجدل عما إذا كان نظام السيسي يشكل إمتدادًا أم قطيعة مبرمة مع نظام يوليو – وهو جدل يترك للباحثين – ولكن ما يعنينا هو التنبيه لملامح التفرد في حقبة ما بعد يوليو ٢٠١٣ والتي تغيب على قوى المعارضة التي تتبني رواية “استمرارية النظام”، ومن ثم تقودها لحسابات خاطئة أو كارثية في بعض الأحيان.
على العكس من ظباط يوليو ١٩٥٢، لم يحكم الجيش قبضته على جهاز الدولة في يوليو ٢٠١٣ مستلهمًا أي رؤية سياسية تُذكر أو ذات مضمون محدد. بل كان تدخله امتدادًا لهيمنته على مفاصل الحكم بعد رحيل مبارك – وهي هيمنة رغبت فيها قيادات المؤسسة العسكرية طويلًا ووقعت في أيديها جاهزة بحكم الفراغ السياسي الشامل الذي خلقه ورعاه مبارك. وبالتالي، فتدخل الجيش هنا كان كمؤسسة منضبطة وموحدة خلف قيادتها وغير مسيسة بالمعنى الحزبي الضيق، في حين أن تدخل ظباط يوليو الأول كان من قبيل تنظيم سياسي يضم أخلاطًا اشتراكية وإسلامية ووطنية (تنظيم الظباط الأحرار) تناصب فكرة الديمقراطية التمثيلية العداء وتراها مسئولة عن تدهور أحوال المجتمع ومن ثم تسعى هي بتدخلها لانقاذ مصر وفقًا لفكرة سياسية محددة. بالتالي كان انقلاب يوليو الأول بمثابة انقلابًا لمجموعة سياسية صاحبة مشروع محدد على قيادة الجيش بالأساس قبل أن يكون انقلابًا على حكم ديمقراطي منتخب، في حين كان انقلاب يوليو ٢٠١٣ هو تتمة لهيمنة الجيش كمؤسسة على مفاصل حكم الدولة المصرية المتداعية بدون رؤية ولا وجهة. ومن هنا كان خطاب الجيش في يوليو ٢٠١٣ خطابًا وطنيًا مجردًا خاويًا من أي مضمون ويحض على استعادة هيبة الدولة كجهاز، وضبط العلاقات الاجتماعية القائمة كما هي بدون أي تغيير يذكر بعد أن تعرضت لتهديدات عميقة بحكم التجذير المتواصل لجميع مكونات المجال السياسي الجديد يمينًا ويسارًا. مشروع السيسي للحكم، والذي رصدنا بداية تشكل ملامحه الأولى في تقريرنا السياسي الثاني، كان مشروعًا لاستعادة الدولة مُعرفةً بأبسط معانيها بداهةً، أي كجهاز يحتكر العنف المادي المشروع ويقوم على تنظيم العلاقات الاجتماعية الرأسمالية في حالتها الراهنة: لا فكرة سياسية ناظمة ولا مشروع محدد. وربما كان ذلك تحديدًا هو السبب في حماس قطاعات جماهيرية متعاظمة لهذا المشروع في البداية، بل وحماس مجمل النخب السياسية المدنية.
إلا أن التاريخ علمنا عبر فصوله المتوالية القاسية أن الدولة ليست جهازًا معلقًا في الفراغ يهيمن على المجتمع من علٍ ويضبط علاقاته وفقًا لمنطقه الداخلي الرشيد، بل أن الدولة كانت ولا زالت، منذ بزوغ الرأسمالية، علاقة وجهاز محكومين في وظائفهم بمستوى التطور المادي المتحقق لقوى الإنتاج وتوازنات القوى الاجتماعية المرتبطة به إلى جانب طبيعة الأيديولوجية المهيمنة. والجيش كمؤسسة محتكرة للعنف المادي وتتشكل حولها كافة مؤسسات الدولة الأخرى، ليس استثناءًا من هذه العملية وتتبلور توجهاته في ضوءها. وبالتالي، وتحديدًا لانتفاء الطابع الحزبي أو المسيس عن انقلاب السيسي، فكان من الطبيعي أن يكون محكومًا أكثر من غيره بتوازنات السياق الاجتماعي والفكري المختل تمامًا باتجاه اليمين.
فعبر الثلاثين عامًا الكئيبة من الركود المباركي تم استيعاب القيادات العسكرية، ومجمل جسم المؤسسة القادم من خلفيات برجوازية صغيرة أو مهنية متدنية بطول البلاد وعرضها، في الأفق الأيديولوجي الحاكم للتراكم الرأسمالي خلال حقب الليبرالية الجديدة. وهذا الاستيعاب تم عن طريق التدخل المتعاظم للجيش كمؤسسة في السوق، سواء كمالك لرأس المال، كما في حالة الأراضي، أو كمنفذ لعدد من المشروعات في قطاعات البنية التحتية أو بعض الصناعات الاستهلاكية، وكذلك عن طريق التلقين الأيديولوجي في الأكاديميات العسكرية. وهذا الاستيعاب تم بشكل بطئ وعبر عقود ولم يأخذ شكل التحولات المفاجئة.
وبالتالي فالأفكار المجردة للتنمية والتقدم والنهضة وغيرها باتت الآن تُعرّف بشكل طبيعي وتلقائي بالإحالة لأفكار الليبرالية الجديدة وما تقتضيه من إعادة هيكلة توجهات مصر الإقليمية في اتجاه مراكز التمويل الرأسمالي سواء في الخليج أو مؤسسات التمويل الدولية أو المراكز الرأسمالية الغربية والاقتصاديات الصاعدة. وبينما كانت التنمية تُعرّف، مثلًا، خلال حقب مابعد التحرر الوطني – وهي الحقب التي شهدت ميلاد نظام يوليو ٥٢- شمالًا وجنوبًا بالمناسبة، بضرورة تعظيم المدخرات المحلية وتوسيع السوق المحلي عبر برامج الضمان والرفاه والاتجاه للتصنيع التدريجي للوفاء باحتياجات هذا السوق المتوسع، تُعرّف التنمية الآن وفقًا للعقيدة الأيديولوجية الجديدة المهيمنة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي بالعكس تمامًا: أي بضرورة تخفيض النفقات الحكومية وفرض التقشف لتشجيع رأس المال المحلي واجتذاب رأس المال الأجنبي والرهان على تساقط ثمار النمو المتحقق على المدى البعيد على مختلف القطاعات الاجتماعية. بعبارة أخرى، فالمفارقة الفاقعة أن الحفاظ على الدولة من وجهة نظر المؤسسة العسكرية كان يقتضي تحديدًا تفكيك العقد الاجتماعي الذي قامت عليه دولة يوليو.
كانت سياسات السيسي محكومة إذًا بالانحراف الحاد يمينًا منذ اليوم الأول بحكم نزعتها الدولتية ووطنيتها المجردة بالتحديد، وليس بسبب خيانة أو عمالة القائمين على تلك السياسات. ليس في الأمر خداعًا أو كذبًا أو نفاقًا، بقدر ما أنها كانت الوطنية في آخر طبعاتها في مصر والعالم على حد سواء – وطنية منزوعة المحتوى الاجتماعي ولا تسعى إلا لتسهيل عمل رأس المال.
وهنا يصعب الحديث عن نظام السيسي كامتداد تلقائي لنظام يوليو بحذافيره، إذ أنه ينبني بالأساس على أنقاض الرشوة الاجتماعية التي استندت إليها رؤية ظباط يوليو ١٩٥٢ وتتبلور رؤيته عن إغلاق المجال العام والسياسي ليس بوصفه إجراء مؤقت حتى تحقيق هدف وطني أو تنموي ولكن بوصفه وضعًا دائمًا تقتضيه ضرورة تأدية الدولة لوظائفها كدولة. هذا باختصار وضع سلطوي يميني لم يقترب منه نظام يوليو في أي من أطواره بل ولم تحلم به النخبة الليبرالية الجديدة تحت قيادة جمال مبارك في الأيام الأخيرة لحكم أبيه وذلك نتيجة لتوازنات القوى الدقيقة التي حالت دون انفراد جناح واحد من أجنحة نخبة الحكم بالقرار في ذاك الوقت.
هنا تتجلى المفارقة الثانية الفاقعة في مصير الدولة المصرية، وهي أن انفراد النخبة العسكرية الكامل بالقرار كان أحد الآثار الجانبية للثورة المصرية ذاتها والتي أطاحت بكل منافسي العسكريين من مقاعد الحكم دون أن تتمكن جماهيرها من ملء الفراغ الناشئ عن هذه الإطاحة. وفي هذا الفراغ والتركز غير المسبوق للسلطة تشكلت إمكانية مشروع الدولة طليقة العقال في مواجهة المجتمع ومن ثم تشكلت إمكانية الانجراف اليميني السلطوي غير المسبوق.
الأربع سنوات الماضية هما التحقق الفعلي لهذه الإمكانية على مختلف الأصعدة والتي ابتعدت بهذا الحكم أميالًا عن حكم الظباط السابقين. فعلى صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية يتوسع الجيش أكثر فأكثر في أنشطته الاقتصادية المباشرة وتتنوع تلك الأنشطة لتخرج بها عن نطاق الاستثمار في البنية التحتية والصناعات المحدودة لتشمل كافة مناحي الحياة تقريبًا. ويستند هذا التوسع لخليط من مصالح مباشرة للقمم البيروقراطية العسكرية مع تصور مفاده أن رمي الجيش بثقله الاقتصادي كفيل بجر القطاع الخاص من خلفه لإنعاش السوق المحلي. وبالطبع لاقى هذا التدخل المباشر هوى لدى قطاعات معتبرة من رؤوس الأموال الخليجية بحكم انشغالها بطي حقبة الثورات العربية بشكل نهائي، حتى وإن كانت غير راضية بشكل كامل عن نتائج أنشطة الجيش الاقتصادية، فالجيش شريك مضمون في التحليل الأخير، بحكم عدم خضوع أنشطته للحد الأدنى من معايير الشفافية.
وبالتوازي مع ذلك، ولتمويل هذا التوسع غير المسبوق في مشروعات البنية التحتية والطاقة خصوصًا، كان الاقتراض، سواء عبر الاقتراض المباشر أو عبر طرح أذون الخزانة. محصلة الأربع سنوات كانت تضاعف الدين الخارجي تقريبًا ليقفز من ٤٦ مليار دولار في يوليو ٢٠١٤ إلى حوالي ٨١ مليار دولار في سبتمبر ٢٠١٧، كما تضاعف الدين المحلي بدوره. فقد قفز الدين المحلي من ١٨١٦.٦ مليار جنيه إلى حوالي ٣١٦٠.٩ مليار جنيه في نفس الفترة. وبالطبع يأتي على رأس هذه الديون وأكثرها شهرة قرض صندوق النقد الدولي البالغ حوالي ١٢ مليار دولار بمشروطيته المعروفة والتي تشتمل على تخفيض مخصصات الدعم وخفض الإيرادات الضريبية على الدخل والتوسع في ضرائب الاستهلاك كضريبة القيمة المضافة.
وبالفعل، شهدت هذه الفترة تخفيضًا تدريجيًا للدعم على المحروقات بدأ في صيف ٢٠١٤ وكانت آخر حلقاته في هذا الصيف، ومن المتوقع وفقًا لبنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يستمر تخفيض الدعم على شرائح استهلاك الكهرباء والذي بدأ بدوره في الصيف الماضي، ثم رفع أسعار بعض الخدمات العامة الحيوية كتذاكر مترو الأنفاق، وهو ما تم بدوره. وبالتوازي مع فرض ضريبة القيمة المضافة، استمر تعليق تطبيق الضريبة على أرباح البورصة لمدة ثلاثة أعوام أخرى تنتهي في ٢٠٢٠ كما تم تمديد فترة استثناء الدخول العليا من حد ال٣٠٪ لنفس المدة. وكذلك تخلفت الموازنة العامة للدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والذي كان مقررًا أن يبدأ تنفيذه العام الماضي. وبالطبع أصدرت الحكومة في نوفمبر ٢٠١٦ قراراتها الشهيرة بتعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة البنكية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، قطع السيسي أشواطًا في التنسيق الأمني مع مركزي الطائفية والسلطوية في الشرق الأوسط – إسرائيل والسعودية – لم يجرؤ مبارك على أن يقطعها في عز هيلمانه، بل تحول التنسيق الأمني مع إسرائيل في سيناء، وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسيطيني، إلى أمر واقع يعترف به القائمين على الأمر في القاهرة وتل أبيب، ناهيك عن التذيل الفضائحي للسعودية الذي كُلل بالتنازل المهين عن جزيرتي تيران وصنافير وكذلك عن حوالي ألف كيلو متر مربع من سيناء في ضوء دعم مشروع “نيوم” الذي يقوم عليه ولي العهد والرجل السعودي القوي محمد بن سلمان. كذلك، يتقارب السيسي مع أحط إدارة أميريكية مرّت على العالم منذ قرن تقريبًا وهي إدارة ترامب، ويتوسع في مشتريات السلاح من الإدارات الأوروبية المماثلة في انحطاطها لإدارة ترامب كإيمانويل ماكرون أو فلاديمير بوتين. وهذا التقارب مع الأجنحة اليمينية المتطرفة وصل بالأخيرة أن تكون المدافع الأول عن نظام السيسي داخل دولها بدعوى مساهمته الفعالة في الحرب على الإرهاب إلى الحد الذي وصل بأمثال الجبهة القومية المتطرفة في فرنسا أن تكون الداعم الرئيسي للسيسي في البرلمان الأوروبي، وباللوبي الصهيوني أن يكون المدافع الأول عن نظام السيسي في الولايات المتحدة. وهذا الانخراط النشط في التيار اليميني العالمي تروج له الأبواق الإعلامية للنظام بوصفه تنويعًا في علاقاتنا الدولية.
ويتم تحصين توجهات السيسي الصادمة بترسانة من القوانين والسياسات القمعية غير المسبوقة بدورها والتي يمكن وصفها بدون مبالغة بحكم الإرهاب الصريح. فعلى صعيد إغلاق المجال العام وتجريد جماهير الشعب المصري من أي إمكانية لمقاومة هذا العصف الممنهج بمقدراته، استمر التغول على استقلال النقابات العمالية بإقرار قانون جديد في نهاية ٢٠١٧ يحد من الاستقلال المحدود والنسبي الذي تمتعت به النقابات المستقلة ويغلق الطريق على إمكانيات تشكيلها في المستقبل، علاوة على التدجين الفعلي للقائم منها بضمه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما أوضحت الانتخابات النقابية الأخيرة بوضوح. كذلك يستعيد الحكم هيمنته على ما فقده من مواقع في النقابات المهنية كما تشي بذلك انتخابات نقابة الصحفيين والمهندسين العام الماضي. وبالتوازي، لا يكتفي الحكم بفرض هيمنته على الإعلام المرئي والمطبوع والمسموع عبر اختراع الهيئة الوطنية للإعلام لتشكل رقيبًا فعليًا على محتوى المادة الإعلامية المقدمة، ولكنه خلع برقع الحياء تمامًا وانتهج سياسة نشطة في حجب المواقع الإلكترونية سواء المعارضة أو المحايدة الاحترافية حتى وصل عدد المواقع المحجوبة حوالي ٤٠٠ موقع مع بداية العام الحالي وفقًا لأكثر التقديرات تفاؤلًا. بل ويصل الأمر عند انتهاء الولاية الأولى إلى الضرب يمينًا ويسارًا دونما تمييز بهدف عرقلة أي إمكانية لحراك ديمقراطي مهما كان هامشيًا وآية ذلك تمدد دائرة الاعتقالات لتشمل رؤساء ومؤسسي ونشطاء أحزاب علنية ومشهرة بدءًا من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وانتهاءًا بالسفير معصوم مرزوق والأستاذ رائد سلامة. أما عما يواجهه حزبنا الناشئ ومرشحه السابق لرئاسة الجمهورية من ملاحقات أمنية وقضائية فحدث ولا حرج.
وأخيرًا، وحتى تكتمل الدائرة، يتم إطلاق يد الشرطة في مواجهة عموم المواطنين وتحصينها من الحساب على الرغم من إزهاقها لأرواح المواطنين بشكل شهري تقريبًا، بغرض إرهاب عموم الناس وترسيخ الانطباع أن نخبة الحكم الجديدة لا تخضع لمحاسبة ولا قانون من أي نوع. بل وامتد الأمر للافتئات على ما تبقى من إرث منظومة العدالة الجنائية، المعقول نسبيًا مقارنة بالكثير من دول المنطقة، بتعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية ثم إعلان حالة الطوارئ بكل ما تخل به من ضمانات المحاكمة العادلة.
هذه هي ملامح أربع سنوات من السلطوية والنهب وإرهاب الدولة الذي يفترض أن نتطلع لجني ثمارهم في السنوات الأربع المقبلة!
رابحون وخاسرون:
السؤال الثاني الذي يواجهنا هنا هو: من يتأهب لحصد الثمار؟ من الرابحون من هذه السياسات ومن الخاسرون؟ وفقًا للتحليلات المنهمرة علينا من مراكز البحث ذات التوجه الليبرالي في المراكز الغربية، يبدو نظام السيسي معزولًا عن أي قوة إجتماعية مستفيدة وأن سياساته منحازة ضد القطاع الخاص بالأساس نتيجة توسع الجيش في أنشطته الاقتصادية. في الواقع، لا تسمح لنا هذه التحليلات – والتي تتمتع بقدر من الشعبية في أوساط القوى الديمقراطية للأسف – بالفهم أو التحليل أو بناء استراتيجية.
في المقابل، فنحن نعتقد أن خريطة المستفيدين من حكم السيسي يمكن استكشافها بسهولة بالغة عبر تتبع عوائد هذه السياسات التي تعرضنا لها في القسم السابق، وهي خريطة في مجملها تشير للرأسمالية المالية والاحتكارية وكلاء رأس المال المالي العالمي. بخلاف القمم البيروقراطية العسكرية محدودة العدد، فالقطاع الرئيسي المستفيد من سياسات السيسي هو القطاع الخاص بالأساس والذي ارتفعت نسب مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بشكل متواصل منذ العام ٢٠١٥ حتى وصلت إلى حوالي ٦٧٪ على عكس الشائع من أن توسع أنشطة الجيش يضيق الخناق على القطاع الخاص. والمستفيد الرئيسي داخل القطاع الخاص في المقام الأول هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحًا هائلة نتيجة التوسع في سياسات المديونية ورفع أسعار الفائدة. ويُستدل على ذلك بتفحص أرباح البنوك العشرة الأكثر ربحية في مصر لنكتشف معدلات مهولة في زيادة الأرباح وصلت حد ٧٨.٤٪ بالنسبة لبنك الكويت الوطني في نهاية ٢٠١٧ مقارنة بالعام السابق له. ويعد البنك التجاري الدولي هو الأعلى ربحية بمعدل صافي أرباح ٣.٦ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠٪ عن العام السابق له. ومن المنطقي بالطبع أن تنعكس هذه الربحية المهولة على فئات المديرين العاملين بهذه القطاعات أو القطاعات المرتبطة بها. كما أن قطاع البناء والانشاءات هو القطاع الأكثر نموًا حتى الآن حيث بلغ معدل نموه في الربع الأخير من العام الجاري ٩.٦٪. ولا يفوقه نموًا إلا القطاع السياحي بمعدل نمو يقارب ٣٠٪ إلا أن هذا القطاع كان قد بدأ من نقطة بالغة التدني حيث كانت معدلات نموه بالسلب في الواقع حتى العام الماضي. وهو ما يعني أن قطاع البناء والتشييد ينتعش بشكل مستمر وثابت بسبب التوسع غير المسبوق لاستثمارات الدولة بالأساس (العاصمة الإدارية الجديدة مثلًا) والتي يستفيد منها بالتبعية القطاع الخاص العامل في هذا القطاع. ويفوق معدل النمو في هذا القطاع معدلات النمو في القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية مجتمعة، بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية من تكرير بترول وخلاف ذلك والذي لم يتجاوز معدل نموه حاجز ال ٤.٨٪. وإذا أضفنا لهذه الصورة معدلات الاعفاءات الضريبية سابقة الذكر تتشكل لنا فكرة مبدئية – في ضوء غياب الشفافية عن البيانات الحكومية- عن خريطة المستفيدين في ولاية السيسي الأولى.
الجدير بالذكر أن القائمين على الغالبية العظمى من الاحتكارات المستفيدة هم أنفسهم رجالات جمال مبارك الذين أعادوا تقديم أنفسهم كرجالات “تحيا مصر”. بنظرة سريعة على رؤساء لجان الموازنة والصناعة في مجلس النواب تطالعنا أسماء كالسويدي، ملك صناعة الكابلات، وغيرها. هذا لا يعني أننا بصدد استمرارية ما لما قبل ٢٠١١ أو إعادة إحياء لعصر مبارك. في الواقع، فالعكس تمامًا هو ما يحدث. فهذه الطغمة المحتكرة قد سلمت تمامًا بقيادة النخبة البيروقراطية العسكرية وسيطرتها على مفاصل القرار وأقلعت عن أي طموح لتمثيل سياسي مستقل. ولماذا تطمح في ما هو أكثر من ذلك؟! فهي تتمتع بأوضاع احتكارية ونفاذ مباشر لقمة هرم السلطة وتحصين لمكتسباتها بالقمع والترهيب، فلماذا تُخضع نفسها لضغوط الانكشاف أمام الرأي العام كطبقة صاحبة مشروع سياسي مستقل؟! هذه الفئات تعلمت درس يناير جيدًا وهو أن تصديها لتمثيل مصالحها بالأصالة عن نفسها يعرضها لما لا تطيق من ضغوط، فكان الاستتار وراء الجيش هو الحل الأمثل سواء بالشراكات المباشرة أو بالتسليم بهيمنته السياسية. ويفسر ذلك جزئيًا سعيها الدؤوب لإقناع السيسي بتشكيل حزب تستتر تحت رايته، التي سيحملها بطبيعة الحال عدد من اللواءات المتقاعدين، ويفسر كذلك تباطؤ السيسي في هذه الخطوة والتي يرى حتى الآن أنها تحمله هو نفسه بأعباء فئات لصوصية قد تعرضه هو لتحمل أوزارهم.
هذه الفئات المستفيدة ليست صاحبة مصلحة بكل تأكيد في أي مشروع ديمقراطي بقدر ما أن استثمارها في السلطوية هو استثمار استراتيجي وعميق. وهي بالطبع ليست صاحبة أي مصلحة في نمو متجانس يهدف للتشغيل والتصدير، ناهيك عن قدر من العدالة الاجتماعية أو الرفاه، هذه أهداف ليست في وارد التفكير فيها من الأصل. حتى الآن ما زال معدل الربحية على الاستثمار في خدمات الدين الحكومي وإدارة المحافظ المالية الخليجية والمضاربة أعلى بمراحل من الاستثمار في القطاعات الصناعية، على الرغم من تعطش السوق للاستثمارات الصناعية أخذًا في الاعتبار هيكل الواردات المختل. فحوالي ٤٠٪ من هيكل الواردات المصرية إذا ما خصمنا مصادر الطاقة والمواد الخام الأخرى، هو سلع نصف مصنعة تشكل مدخلات إنتاج لسلع أخرى. ولا يعني ذلك إلا أن التوسع في تصنيع مدخلات الانتاج تلك هو أمر ممكن ومربح. ولكن مرة أخرى فمعدل الربحية في القطاع الصناعي لا يقارن بالاستثمار في القطاعات الأخرى أخذًا في الاعتبار ارتفاع معدلات الفائدة على القروض والودائع. الرابحون من حكم السيسي إذن ليسوا في وارد التفكير في تنمية أو ديمقراطية.
فماذا عن الخاسرين؟ كما هو الحال بشأن خريطة الرابحين، يمكننا كذلك تتبع خريطة الخاسرين من سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من واقع مؤشرات الأداء على هذه الساحات جميعها خلال الأربع سنوات الماضية. فتعويم الجنيه المصري في سوق كالسوق المصري، معتمدة بشكل محوري على الواردات لسد الطلب على السلع الاستهلاكية، علاوة على تخفيض الدعم على المحروقات، قاد لواحدة من أعنف موجات التضخم في تاريخنا الحديث تقريبًا. فمع نهاية العام الماضي، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى ٣٠.٧٪ مقارنة ب ١٤.٥٪ في العام السابق له و١٠٪ فقط في ٢٠١٤. هذه الموجة التضخمية العاتية مع معدلات النمو المتواضعة، والتي لم تؤد لتراجعات ملفتة في معدلات البطالة وعدم تحريك الحد الأدنى للأجور، ترجمت نفسها سريعًا في ارتفاع معدلات الفقر المطلق الأمر الذي دفع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نفسه للتصريح أن معدل الفقر مرشح للارتفاع من ٢٨٪ وفقًا لآخر إحصاء في ٢٠١٥ إلى ٣٥٪ في العام الحالي. هذا مع العلم أن التقدير الرسمي لمعدلات الفقر لا يتبع المعايير العالمية التي تقدر عدد الفقراء المصريين بحوالي ٤٢٪.
بعبارة أخرى، فنصف المواطنين المصريين قد أصبحوا من الفقراء. نصف السكان هؤلاء بمتابعة مؤشرات التنمية البشرية للمحافظات وأماكن الكثافة السكانية العالية، يشكلون كتلة مهولة من العاملين في القطاع غير الرسمي بالأساس والقطاع الخاص ثم جهاز الدولة فالقطاع العام الصناعي، هذا بخلاف العاطلين والتي تبلغ نسبتهم حوالي ١٢٪ من قوة العمل. وبالقطع تشمل تلك النسبة قطاعًا معتبرًا من العمال الزراعيين والفلاحين ذوي الحيازات الصغيرة، وإن كانت نسبة التحضر السريعة لم تترك مجالًا إلا للحديث عن مراكز يغلب عليها الطابع الريفي أكثر من الحديث عن ريف بالمعنى المطلق في مواجهة حضر بالمعنى المطلق. تتسع تلك الكتلة الحضرية كذلك لتشمل قطاعات واسعة من البرجوازية الصغيرة العاملة في القطاع التجاري بل وحتى صغار المستثمرين من ذوي المشروعات متناهية الصغر أو ذات التمويل المحدود والتي ألقت بهم سياسات الإئتمان القاسية مع ارتفاع معدلات الفائدة خارج دائرة المنافسة.
هذه القطاعات لا تقتصر معاناتها على دخولها دائرة الإفقار، ولكن يضاف إليها حرمانها المتصاعد من نصيب كريم من الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل نتيجة تراجع الاستثمار العام في هذه القطاعات، وذلك على الرغم من تراكم رأسمال هذه القطاعات بالأساس عبر مدخرات أجيال من هؤلاء الخاسرين أنفسهم. وبتراجع نصيب الأسرة من هذه الخدمات تتراجع فرص الترقي الاجتماعي والمنافسة في سوق العمل وتعيد التفاوتات الطبقية إنتاج نفسها في دائرة لا تنتهي تشرف عليها عصى الجنرالات الغليظة.
وداخل هذه الكتلة العريضة، تتحمل الفئات التي عانت تاريخيًا، ولازالت تعاني، من اختلال موازين القوى الاجتماعية بحكم عوامل ثقافية وسياسية، نصيبًا أكبر من المعاناة، وفي القلب من تلك الفئات النساء بالطبع. هنا يؤدي رسوخ العلاقات الأبوية والوعي المصاحب لها لتهميش مضاعف. فوفقًا للإحصاءات الحكومية نفسها، لم تتجاوز نسبة النساء من مجموع قوة العمل في مصر نسبة ال٢٠.٦٪ وذلك على الرغم من تشكيل النساء المعيلات نسبة تتجاوز ٢٦٪ من المصريين تحت خط الفقر: أي حرمان فادح ومضاعف من أي فرص للترقي الاجتماعي. وكذلك تزيد نسبة البطالة بين النساء إلى ٢٤٪ بينما تبلغ في أوساط الذكور نسبة ٩.٤٪.
ولا يتوقف التفاوت عند فرص الدخول لسوق العمل كطريق للخروج من دائرة الفقر والتهميش ولكنه يمتد لمواقع العمل نفسها في صور متنوعة. ثمة تفاوت بين القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء، وهو لصالح القطاع العام هذه المرة، فعلى الرغم من أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هو ١٢٢٠ جنيهًا، وهو ما يزيد على متوسط أجور العاملين الرجال والذي يبلغ ١٠٤٢ جنيهًا، إلا أن متوسط الأجور في القطاع الخاص، وبالتحديد في المنشآت التي يعمل بها أكثر من عشرة عمال، كان بالنسبة للنساء ٥١٠ جنيهًا مقابل ٥١٥ جنيهًا للرجال. ويزداد الأمر فداحة في القطاع غير الرسمي بطبيعة الحال. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة بشكل كامل عن علاقات العمل في هذا القطاع، إلا أن أقرب الإحصاءات الرسمية للدقة تشير إلى أن نسبة حوالي ٧٣٪ من النساء المشتغلات يعملن بأقل من ثلث الأجر العام.
و يتخذ التمييز ضد المرأة في مواقع العمل أشكالًا ترقى للعنف عبر التحرش والذي يشكل قيدًا موضوعيًا إما على التوظيف من الأساس أو على القدرة على المفاوضة بهدف تحسين شروط الاستغلال. وتتراوح التقديرات حول نسبة النساء العاملات اللاتي يتعرضن للتحرش في مواقع العمل بين التقديرات شبه الرسمية التي تقدرها بحوالي ٣٠٪، وفقًا لإحصاءات سكرتارية المرأة بالاتحاد العام لعمال مصر، وبين حوالي ٨٩٪ وفقًا لتقديرات بعض مؤسسات المجتمع المدني! وتزيد النسبة خارج مواقع العمل بطبيعة الحال مما يخلق حواجز إضافية تحول بين النساء وبين الخروج من دائرة الفقر والتهميش كما سبق الذكر.
أما جمهور الأقليات الدينية والمذهبية، وفي القلب منه مسيحيو مصر – الذين رأت قطاعات معتبرة منهم في مشروع السيسي طوق نجاة من العنف الطائفي الذي قادته أو شجعت عليه أو تغاضت عنه فصائل التيار الإسلامي خلال حكم محمد مرسي- فتحصد بدورها ثمار سياسات نخبة الحكم المتفرغة للنهب والتي لا تمتلك الهم ولا الرغبة ولا الشجاعة للتصدي لمهمة بناء علاقة مواطنة كاملة دون تمييز أو مواجهة الاتجاهات الطائفية التي تعشش في كل ركن من أركان الدولة المصرية. فالوعود الرسمية، والنصوص الدستورية، بشأن قوانين عادلة لبناء دور العبادة أو مكافحة التمييز الديني، مازالت حبيسة الأدراج. بل أن الوضع فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية قد صار أسوأ مع تمرير قانون مجحف لبناء الكنائس في العام الماضي حظى برعاية الكنيسة المصرية مع الأسف. وحوادث العنف الطائفي عادت للتصاعد، خصوصًا في صعيد مصر كما رأينا الشهر الماضي في المنيا، ومعها تخاذل أمني فاضح وجلسات صلح عرفية لا تحقق الحد الأدنى من الكرامة للمواطنين المصريين.
هذه الصورة تزداد قتامة إذا أضفنا لها عامل الترهيب الرسمي العام الذي يعمل على تجريد عموم المصريين من أي أداة للتفاوض الجماعي وكذلك مع تقلص نفوذ العلاقات الشخصية والعصبيات العائلية والتي رعاها الحزب الوطني يومًا ما. هنا أيضًا، لا تطابق كامل مع نظام مبارك ولا استثناء عن الميل الغالب في نمط الانتاج الرأسمالي اليوم الذي يتنكر للديمقراطية الليبرالية والتمثيلية مع اشتداد وطأة أزماته.
المشهد المعارض: مراوحة في المكان!
بخصوص المعارضة الديمقراطية الناشئة في خضم يناير ٢٠١١، فلا جديد تحت الشمس حتى الآن، إن لم تكن أوضاعها في تدهور مستمر. فبعيدًا عن الضربات الأمنية المتلاحقة التي نالت من القدرات التنظيمية لهذه المعارضة وخلقت حالة من اليأس العام والإحباط والهروب إلى الحلول الفردية، لا زال من تبقى من تلك المعارضة – التي أبلت بلاءًا حسنًا للغاية خلال العامين الأولين بعد رحيل مبارك- عاجزة عن إدراك ملامح نظام السيسي المتفردة كما سبق الذكر. ومازالت ترى فيه تلك المعارضة إما امتدادًا لنظام يوليو ١٩٥٢ بحذافيره أو استثناءًا عن الميل العالمي العام الأمر الذي قد ينال من شرعيته حتمًا نتيجة اعتماده شبه الحصري على الغرب…. هكذا تعتقد!
تؤدي التصورات الخاطئة إلى جملة من الحسابات الخاطئة والتي تجعل تلك المعارضة فريسة سهلة للضربات الأمنية في التحليل الأخير. فاعتبار نظام السيسي امتدادًا لمعادلة يوليو ١٩٥٢ في الحكم بحذافيرها، دائمًا ما يدفع جماعات من تلك المعارضة الديمقراطية إلى افتراض وجود تعدد في مراكز القوى مماثل للتعدد الذي وسم نظام يوليو. ومن ثم تنزع للتفكير بشكل لا يعرف الكلل ولا الملل في التحالف مع أجنحة من نخبة الحكم، أو على الأقل دعمها المعلن أو غير المباشر، بهدف تأزيم موقف النظام. ويقترن بذلك حساب خاطئ آخر يرى أن هذا النظام معزول دوليًا، أو على أقل تقدير، أنه بحكم شذوذه عن الميل العالمي المفترض باتجاه الديمقراطية الليبرالية يسهل ابتزازه دوليًا، أو غربيًا على وجه الخصوص. يقترن الحسابان معًا لينتجا استراتيجية غريبة تنسحب بشكل دائم من أي استحقاق انتخابي أو أي فرصة مهما كانت ضئيلة للتعبئة الاجتماعية على أمل أن يخلق هذا الانسحاب تأزيمًا لموقف السيسي في صراعه المفترض مع أجنحة نخبته بما يدفعه دفعًا لتقديم تنازلات على صعيد الحريات والآليات الديمقراطية. خبرة حملة خالد علي الانتخابية تعتبر مثالًا دالًا على ذلك، حيث قابلت معظم أجنحة تلك النخبة محاولة ترشحنا بفتور معلن أو مبطن. وفي كل الأحوال كان قلب وعقل المتشككين في معركتنا في موقع آخر- عند صراعات شفيق وعنان وجنينة وغيرهم.
حاولنا التدليل في أكثر من موضع في تقريرنا على خلل هذه الفكرة الكامل وانفصالها عن الواقع. فنخبة الحكم كانت ولا زالت، حتى الآن على درجة غير مسبوقة من التماسك، بحكم الملابسات التي قادتها للسلطة كما سبق الذكر، وهي ملابسات دفعت بالجيش كمؤسسة موحدة وذات مصلحة متجانسة تقريبًا لمواقع السلطة. كذلك كان التدخل الحاسم للجيش مؤشر مريح للطغمة الرأسمالية المالية والاحتكارية دفعها مرة أخرى للانضواء تحت مظلة العسكريين ولسان حالهم يقول أن نارهم أهون من جنة الديمقراطية. هنا نود أن نشدد أن نظام يوليو لم يعرف في تاريخه الطويل أي مستوى من مستويات تماسك نخبته على هذا النحو. كان هذا النظام محكومًا دائمًا بصراعات بين الرجل الأول في الاتحادية والرجل الثاني المتحكم في الجيش، أو بين قادة الأجهزة الأمنية وبين العسكريين المهمشين من مواقع القرار، أو بين القلب الأمني/العسكري للنظام وبين جهازه السياسي، أو، في مرحلة لاحقة، بين القلب الأمني/العسكري والطغمة المالية التي تسعى لتمثيل سياسي مستقل. لا يوجد شئ من هذا القبيل اليوم في نظام السيسي. تبدو كافة أجنحة النخبة قانعة بشكل عام بمواقعها الجديدة، ويبدو أن قناعتها ستدوم لوقت قد يطول. ولهذا كانت دهشة النخب المدنية الديمقراطية مما حدث لعنان مثيرة للدهشة بحد ذاتها، أخذًا في الاعتبار ما تنم عنه من عدم قدرة على قراءة حقائق واضحة وضوح الشمس.
وفي المقابل، فتصور أن هذا النظام قابل للابتزاز أو الإحراج دوليًا، لا يأخذ في حسبانه أن السيسي هو طرف، أو شريك أصغر، في تحالف يميني عالمي يقود أعنف هجوم على الطبقات العاملة، بل والديمقراطية في المجمل، منذ عقود، وأن عالم ما بعد الحرب الباردة قد انتهى لزمن قد يطول، على الأقل لأربع سنوات إضافية هي فترة السيسي الرئاسية القادمة. هذا التحالف العالمي لا يرى في عالمنا العربي إلا كم مهمل من ٤٠٠ مليون إنسان يجب وضعهم تحت السيطرة عبر حكام محليين يكفي العواصم الغربية شر مراكب اللجوء. المحصلة في النهاية هي استراتيجية انسحابية لا تهدد نخبة الحكم الضيقة وبالطبع لا تهدد الحلف الحاكم بالمعنى الواسع للكلمة.
من المفهوم أن تراوح القوى المدنية الديمقراطية في مكانها على هذا النحو أخذًا في الاعتبار كونها تنهل من نفس معين دولة ما بعد الاستعمار الأيديولوجي وخطابها الوطني المجرد وما تحتله الانتلجنسيا أو الفئات المتعلمة من الطبقة المتوسطة من مكانة محورية فيه. تدرك هذه القوى نفسها، كما النخبة العسكرية في الحقيقة، بوصفها متمثلة لروح وطنية فوق الطبقات والصراعات الاجتماعية وهدفها النهائي هو إلحاق الشعب المصري إلحاقًا بالعصر الحديث. ولكنها تختلف بالقطع مع مسار السيسي من حيث تقديرها لفكرة السيادة الشعبية في مواجهة النزعة الاستبدادية للسيسي وحلفه الحاكم المعادية للشعب من حيث المبدأ. إلا أن التقدير العام للسيادة الشعبية عندما يقترن بالوعي المجرد المتعالي على الطبقات فهو ينتج تلك الممارسة الملتبسة التي تنتظر أن يسعى إليها الشعب طالبًا منها تمثيله، لا أن تخرج هي من موقعها الاجتماعي وأن تدرك أنه لا خلاص من التهديد الدائم لموقعها إلا بتحالفات إجتماعية بديلة تخالف الرهان على الجهاز الإداري “الوطني” للدولة والبرجوازية الوطنية المفترضة: لا هذه البرجوازية موجودة ولا هذا الجهاز الإداري الوطني موجود… فقط هجوم ضاري على الغالبية العظمى من المصريين لا فكاك منه إلا بالتنظيم الذاتي.
ومن جانب آخر، لا زالت بعض التيارات الإسلامية وفي القلب منها جناح معتبر من الإخوان – الوجه الآخر للانتلجنسيا الوطنية – في تيهها التاريخي تبحث لنفسها عن موطئ قدم داخل نفس الحلف الحاكم بشرط إزاحة السيسي وربما بعض القمم البيروقراطية الأمنية والعسكرية والقضائية. مازالت تلك القطاعات تمني النفس بغنيمة دولة ما بعد الاستعمار التي تسمح لها بإعادة هندسة العلاقات الاجتماعية على مثال أبوي طائفي يكثف الاستغلال والنهب الرأسمالي بعد إضفاء مسحة دينية عليه. معضلة هذه التيارات غير القابلة للحل أنها لاتدرك أن لا أحد يحتاج لخدماتها في الحقيقة. فشرط استيعابها داخل مقاعد الحكم كان ولا زال هو التنكر الكامل لجمهرة المستغلين والمهمشين المذكورة في الصفحات السابقة: هذا هو نمط التراكم الرأسمالي الممكن اليوم من وجهة نظر الحلف الحاكم ولا مكان فيه لشعبوية الإخوان أو تهويماتهم الهوياتية.
أما القطاع الذي يزداد جذرية من الفصائل الإسلامية تجاه اليمين بدءًا من باقي جماعات الإخوان وأجنحتها المسلحة مثل “حسم” و “لواء الثورة” وصولًا إلى باقي فرق السلفية الجهادية حتى “داعش” فهو ينخرط يومًا بعد يوم في عداء عدمي مع جمهور الخاسرين من حكم السيسي معرقلًا إمكانيات النضال الديمقراطي ككل في المجتمع المذعور من خطر الإرهاب الذي أصبح، على أيديهم، فعليًا وحالًا وجديًا.
يبدو السيسي والحال كذلك أكثر تطورًا في تصوراته من قوى المعارضة مجتمعة ويسبقهم في رؤيته للعالم وموقعه منه بخطوة أو إثنين… حقيقة مرّة ولكنها حقيقة في النهاية!
عودة لجني الثمار: تماسك الحلف الحاكم واستراتيجيات النضال الديمقراطي
بعد أن اتضحت ملامح نظام السيسي وطبيعة سياساته، وكذلك تكوين الحلف الحاكم وخريطة الرابحين والخاسرين من هذه السياسات، وموقف المعارضة الديمقراطية، يمكن الختام الآن بمحاولة رسم صورة للمرحلة المقبلة: مرحلة جني ثمار السلطوية والنهب.
على صعيد توجهات الحلف الحاكم وتماسكه، فاستقراء الدلائل وسياق صعود السيسي للسلطة ونجاحه في إقصاء كافة منافسيه الشخصيين العاجزين عن إدراك تطورات الواقع، يشير بأن شهية القمع قد انفتحت أكثر وأكثر. كذلك فمرور إجراءاته الاقتصادية الشرسة بدون احتجاجات تذكر، يغري بالمضي خطوات إضافية في مسار القمع الشامل والتلاعب ليس فقط بالقواعد القانونية القائمة ولكن حتى بدستور “النوايا الطيبة” سواء بفتح مدد الترشح لرئاسة الجمهورية أو بمد فترة الرئاسة الواحدة إلى ٦ سنوات وكذلك السعي لمد نفوذ وجوه النخبة العسكرية/الأمنية وحلفائها للهيمنة على كافة المواقع التشريعية على المستوى المحلي أو النقابي، والتشريعي بطبيعة الحال.
إلا أن هذا السعي الدؤوب يخلق سلسلة من التناقضات يصعب حلها على المدى المتوسط والبعيد، وقد تشكل السنوات الأربع القادمة بداية تبلورها، وهي التناقضات التي تسرعت بعض النخب المدنية الديمقراطية في قرائتها وانتهت بها إلى أحكام خاطئة وملتبسة.
التناقض الأول يتمثل في السعي لتحصين نخبة الحكم من أي أنواء أو تفاعلات شعبية وإحكام عزلتها، من جهة، والسعي في الاتجاه المعاكس لتشكيل ظهير سياسي عريض لنخبة الحكم الضيقة وحلفها الاجتماعي بهدف تشغيل ماكينة التشريع والتنفيذ، من جهة أخرى. فتتحول كل مساحة جديدة تسعى نخبة الحكم للهيمنة عليها إلى مساحة إضافية للتوتر بين أجنحتها. لم تكن هذه المعضلة مطروحة على السيسي في فترته الرئاسية الأولى بحكم عدم اكتمال هياكل الحكم ومؤسساته. البرلمان كان غائبًا والمجالس المحلية مثلًا كانت منحلة بحكم المحكمة الإدارية منذ مارس ٢٠١١. ولكن لم يعد من الممكن استمرار هذا الوضع أكثر من ذلك: إن آجلًا أم عاجلًا يجب تشكيل كتلة من آلاف المرشحين لشغل هذه المواقع. كذلك الحال مع النقابات المهنية والتي تركت نخبة الحكم مهمة السيطرة عليها لمرحلة لاحقة، بل وتسامحت مع سيطرة وجوه محسوبة على المعارضة المدنية الديمقراطية عليها كنقابة الصحفيين والمهندسين والأطباء، وهو ما لا تقبله تلك النخبة بعد الآن. وكلما توسعت النخبة السياسية الجديدة، تنكشف لضغوط هيئاتها الناخبة أكثر فأكثر، حتى ولو كانت تتنكر لها بشكل منهجي، وكذلك تتسع دائرة منتفعي النظام واستحقاقاتهم. وقد يتعقد الموقف إذا اتجه السيسي بالفعل لتشكيل حزب حاكم يضم كل هذه الشلل المتنافسة المشكلة لقوام الطبقة السياسية الموعودة.
التناقض الثاني يتمثل في تصاعد التنافس بين الشلل العابرة لغابة الأجهزة الأمنية، والتي يتسع دورها، ومكاسبها المادية والمؤسسية المحتملة، كلما انفتحت شهية نخبة الحكم للسيطرة على كافة منافذ الحياة العامة وتكثيف وتيرة الإرهاب الأمني. شهدنا ملمح من ذلك التوتر المحتمل على خلفية حادث الواحات الإرهابي في نهاية العام الماضي والذي انتهى بإقالة رئيس الأركان محمود حجازي، وكذلك ما بدا كخلاف بين بعض الأجهزة حول كيفية إدارة الانتخابات الرئاسية وانتهى هذا الخلاف بإقالة اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة السابق وربما اعتقاله وفقًا لبعض التقديرات.
التناقض الثالث والأخير يتمثل في التنافس الممكن بين جماعات الرأسمالية المتحالفة والذي يخلق نمط النمو الحالي ميلًا متزايدًا لترسيخ طابعها الاحتكاري ومن ثم تعميق التنافس فيما بينها بالتوازي مع تعاظم خسائر بعض أجنحتها. مرة أخرى، شهدت الأربع سنوات الماضية مصائر متباينة لوجوه تلك الفئات الاحتكارية من صعود سريع واختفاء أسرع على وقع خلافات بينية أو خلافات مع نخبة الحكم، وتشهد على ذلك حالة السيد أبو هشيمة في مجال الإعلام وصناعات الحديد والصلب. هذا التنافس قد يدفع هذه الشلل، مرة أخرى، للاستثمار في صناعة رموز سياسية متنافسة داخل الطبقة السياسية الموالية المحتملة أو من خارجها.
متى تتصاعد تلك التناقضات وكيف وأي مسار تتخذ، فهذه أسئلة متروكة للمستقبل ولا يجب أن تشغلنا كثيرًا إلا بقدر ما قد تتيحه من هوامش للنضال الديمقراطي، خصوصًا – ونشدد مرة أخيرة- أن نخبة الحكم وتحالفها الاجتماعي مازالت على درجة غير مسبوقة من التماسك حتى الآن على الرغم من تنافساتها البينية.
تخلق هذه الاحتمالات ظروفًا بالغة الصعوبة للنضال الديمقراطي بطبيعة الحال، وإن كانت لا تغلق احتمالاته بشكل كامل. تواجه كل محاولات بناء تيار ديمقراطي اجتماعي مستقل إرهابًا وتوحشًا أمنيًا غير مسبوق وإغلاق متعمد لكافة المنافذ المطلوبة لنموه. وكذلك فرؤى القوى السياسية المنظمة التي قد تشكل جبهات أو تحالفات تصلح كعناوين لهذا النضال، كما حاولنا التوضيح، بالغة التشوش . أما أحوالها التنظيمية فهي لا تسر بطبيعة الحال، كما كشفت عن ذلك حملتنا الانتخابية المبتورة.
ولكن على الجانب الآخر، يشكل تحلل العقد الاجتماعي لنظام يوليو ١٩٥٢ بشكل متسارع وشبه كامل، وانحراف التيار الإسلامي يمينًا وتخارجه الكامل من مسارات النضالات الاجتماعية والديمقراطية، إمكانية تحرير مؤقت لهذا التيار الديمقراطي الاجتماعي الوليد من الأوهام بشأن التحالفات مع أجنحة داخل نخبة الحكم أو أجنحة من التيار الإسلامي، على الأقل حتى تحقيق انتصارات أولية قد تطرحه كرقم في الصراعات السياسية الكبرى في المجتمع.
وحتى يتشكل هذا البديل بشكل مستقل وآمن وتراكمي يجب تكوين جبهة ديمقراطية على أسس جديدة تتبنى برنامج ديمقراطي واجتماعي جذري في انحياراته وبدائله، وواقعي في أهدافه المرحلية وآليات عمله بدءًا من المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية وحتى ممارسة الاحتجاج المحسوب بآلياته المتعارف عليها. كانت تجربة ترشيح خالد علي على علاتها التنظيمية والسياسية تجربة مهمة على طريق بناء هذه الجبهة ولها دروسها المستفادة. وأمامنا عدد من الاستحقاقات الموقعية وغيرها على المستوى الوطني تسمح بمزيد من التجريب.